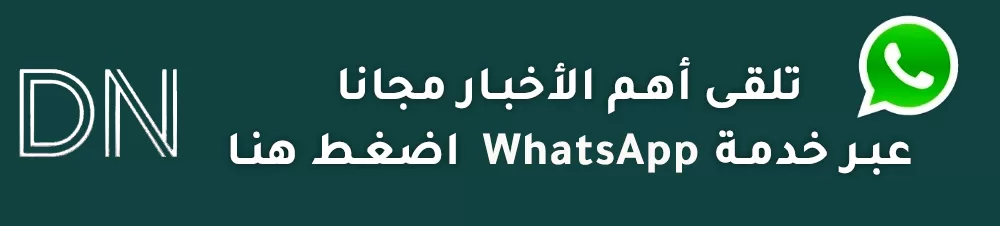من الكهف إلى “واتساب”.. النميمة أقدم وسيلة تواصل بشري

كتبت ريتا عازار في “نداء الوطن”: النميمة واحدة من أنواع الرياضة الثقيلة. سبقت ما عداها، ركضت واحتلت مكانة مرموقة حتى قبل أن يكتشف الإنسان العجلة، وقبل أن يكتشف النار، وقبل أن يقرّر أن يأكل بيضة مسلوقة لأوّل مرّة. من همسة قصيرة وُلدت. جملة سريعة حملت معها دماراً “ناعماً” لسمعة أحدهم… نعم هكذا وُلدت النميمة. ولفهم تاريخ البشرية، من الضروري فهم تاريخ النميمة، أليس كذلك؟ إنها ليست تسلية أو عادة سيئة، بل هي رياضة فذّة، وعمود فقري لكلّ جلسة أو لأغلب الجلسات، والمحرّك الأول لكلّ علاقة اجتماعية، والسبب الخفي وراء كثير من الحروب وحالات الطلاق.
النميمة، ذاك الرحيق “العذب” الذي يسيل من الأفواه كأنّه نبيذ فاخر مغشوش، ذاك الهمس السام الذي نتبادله بين رشفتَين من فنجان قهوة فاترة في المكتب أو في صالون الجيران أو على شرفة الأصدقاء، تلك الجملة: “أنا ما عم قول شي، بس (…)”، التي تسبق دائماً تسونامي من القيل والقال. فلَو كان للبشرية قوة خارقة مشتركة، لن تكون إلا القدرة الخارقة على النميمة بكفاءة مذهلة.
فن قائم
والحقيقة أنّ النميمة فن قائم بذاته، تراث غير مادي للبشرية، يجدر بـ “الأونيسكو” التفكير جديّاً في تصنيفه كما تصنّف الرقصات التقليدية والأجبان ذات الرائحة القوية. النميمة هي تلك اللحظة التي نحوّل فيها حياة شخص ثالث إلى ملحمة سخيفة، إلى مسلسل رديء المستوى، بينما نشعر بتفوّق غريب، وكلّ ذلك مع ابتسامة، طبعاً. ولأننا لا نبصق في الطبق الذي نأكل منه، نعلّق عليه بصوت خافت قائلين: إنه مالحٌ جداً، بينما نغرف لأنفسنا ملعقة ثانية… نفاق؟ أم تراها أناقة اجتماعية؟
على أي حال لا يمكن لشخص أن ينمّ لوحده. يمكنه أن يكون الدينامو نعم، لكن النميمة رياضة جماعية، لا تُمارَس إلا بحدّ أدنى بين شخصَين، في أجواء تآمر اجتماعي خافتة. وتُختم بعبارة: “بصراحة، ما بدي كون شرير، بس (…)”، وتلك دائماً نقطة انطلاق لصفّ من الهجمات السلبية-العدوانية النووية.
الانطلاقة
كان الإنسان البدائي يعيش في الكهوف، يتسلّق الأشجار، ويصارع الديناصورات (أو هكذا نتخيّل). لكن الحقيقة التي لا يرويها أحد، هي أنّ أولى أدوات التواصل لم تكن الحجارة ولا العظام، بل نظرة جانبية وهمسة على شكل: “شفت شو لابسي ماغا اليوم؟ حجرها مش لابق ع إجرها أبداً!”
هكذا، كانت أول جلسة نميمة. والنقوش التي وجدها علماء الآثار على الكهوف، فسّرها البعض كرسوم للصيد، بينما الحقيقة كانت ببساطة “غوغ سرق خنزير برّي وقال لقاه ميّت”. النميمة يومها كانت منقوشة على الصخر بدون خصوصية، بدون خيارات حذف، ما يدلّ على أنّ أول “ستوري” في التاريخ كانت عبر الجدران، وأول “بلوك” كان عبر حفر على حجر.
نميمة القصور
في القصور الملكيّة، كانت النميمة رياضة نبيلة. الخدم يتحدثون عن الملكة، الحاشية تتهامس عن الأمير، والملكة نفسها كانت تدسّ خبراً كاذباً لترى من ينشره، كأنها لعبة شطرنج بشرية، حيث الجملة الخاطئة قد تعدم صاحبها، أو ترفّعه إلى رتبة مستشار شرير.
وفي التاريخ العربي، يُقال إن بعض الخلفاء كانوا يختبرون ولاء حاشيتهم بإطلاق إشاعات عن أنفسهم. من لم يشاركها كان يُكافأ. ومن نشرها؟ يُمنح وظيفة في مكان بعيد غير قابل للعودة.
في عصور الملوك والخلفاء، لم تكن النميمة هواية، بل حرفة، وشبه منصب وزاري غير مُعلن. كل مجلس فيه شاعر، نديم، وواحد اسمه “فلان ابن فلان”، لا يقول شعراً ولا يضحك، لكنه ينقل الحكايا.
في البلاط العبّاسي مثلاً، كانت هناك مهنة غير رسمية تُعرف بـ “الآذان الذهبيّة”، وهي ليست من المجوهرات، بل آذان تعرف كيف تلتقط، تُخزّن، ثم تُسرب. كانت المجالس في ذلك العصر، كما في منصة “أكس” أو تويتر سابقاً، متخمة بالأخبار، والسخرية.
بشّار بن برد، شاعر أعور، لكنه كان يرى أكثر من كثيرين. كان ساخراً، ناقداً لاذعاً، ولسانه كشفرة حلاقة. نقلوا عنه إنه قال: “إذا ما غضبنا غضبةً مضريةً هتكنا حجاب الدين والناس أجمع!”. أبلغوها إلى الخليفة المهدي، فصُنِّفت العبارة على أنها “زندقة بلمسة شعريّة”. النتيجة؟ الجلد حتى الموت. الدرس؟ في العصور القديمة، تغريدة واحدة كانت كفيلة بأن تصبح تذكرة باتجاه واحد… نحو الآخرة.
ياغو والنميمة الأدبية
في مسرحية “عطيل” لوليم شكسبير، كلّ القصة مبنيّة على إشاعة واحدة أطلقها ياغو. شكسبير، ذاك العبقري كان يعرف جيداً كيف ينسج حبكة كاملة من معلومة غير مؤكّدة. ويبدو أنه، مثل كثر، كان يستمتع بحبكات: “سمعت إنو… بس ما تقول لحدا”.
لو عاش شكسبير اليوم، لكان فتح قناة “يوتيوب” اسمها “حكايات بلا دليل”.
ففي مسرحية “عطيل”، كلّ شيء انهار بسبب إشاعة ياغو. جعل الجميع يشكّون في الجميع، ثم وقف على الأطلال ليقول: “ما قصدت… بس قلت هيك بيني وبين نفسي!”.
الأدب عبر العصور استخدم النميمة كوقود، كل رواية بوليسيّة تبدأ بـ “في إشاعة قديمة”. وكل فيلم درامي يرتكز على جملة “سمعت إنّو كان على علاقة، بس مش متأكدة!”.
مقبرة الخصوصية
ندخل العصر الحديث. حيث كلّ شيء يُسجَّل، يُرسَل، ويُسرَّب. “الغروبات” على “واتساب” أصبحت المنصّة الرسميّة للنميمة، خصوصاً “غروب العيلة”. ذلك الفضاء الخانق بين “صباح الخير” وصورة كيكة مقلوبة ونقاش حاد حول: “ليش ما حدا ردّ على عمّتك؟”.
من أخطر ميزات هذا العصر، “أُرسلت عن طريق الخطأ”، وهي الجملة التي دمرت صداقات، فجّرت عائلات، وجعلت بعض الناس يختفون فجأة من “الغروب” بلا وداع.
وفي التسجيلات الصوتية، حيث تتحوّل النميمة إلى “بودكاست” منزلي مدّته 6 دقائق، بصوت الخالة نادرة وهي تحلّل التصرفات المريبة لِكنّة الجيران تجاه رجال المبنى والحيّ كلّه!
حيوانات نمّامة
صدّق أو لا تصدّق، علماء السلوك وجدوا أنّ النميمة لا تقتصر على البشر وأنّ بعض القردة تُحذّر بعضها البعض: “إياك والاقتراب من موزة القائد”. أما القطط فترمق بعضها البعض بنظرات استعلاء عندما تمر قطة سمينة، قائلةً: “تكاد تنفجر من كثرة “الدراي فود”!.
وماذا تفعل الدلافين؟ تُرسل إشارات صوتيّة فيها “تحذير اجتماعي” عن دلافين أخرى كسولة أو مثيرة للجدل!
لا نهاية للنميمة
ربما تخفت، تُجمَّل، تتحوّل إلى “قلق مشروع” أو “تحليل اجتماعي”، لكنّها تبقى حاضرة ناضرة. قد تكون سلاحاً، وقد تكون ضحكة، وقد تكون محاولة لفهم العالم من خلال أخطاء الآخرين.
وعليك أن تتذكّر دائماً، أنه إذا قالوا لك أنّ جلسة القهوة كانت خالية من النميمة، فتأكد أنك كنت الغائب الوحيد عنها، وأنك موضوعها الأوحد!
لكن ما همّ… مهما فعلت لن يمكنك كمّ النميمة، سيكون ذلك كأنك تمنع المطر عن لندن، أو تحظر “الباستيس” في مرسيليا. ما ينبغي فعله هو الارتقاء بالنميمة، تنقيتها، جعلها رقصة ساخرة، مبارزة لفظية، فنّاً دراميّاً يليق بالمآسي اليونانية العظمى، لكن مع أذى أقل إن أمكن!
رجاء نمّ أو نمّي بأسلوب راقٍ، بتلك اللمسة من الفكاهة التي تُحوّل الخبث إلى شعر. فبعد كلّ شيء، إن كان “الجحيم هو الآخرون”، فاضحك واضحكي عليهم بسرعة قبل أن يَصِلوا.